البوليساريو والرياح التي زرعتها
نشرا صحيفة “أتالايير” الإسبانية مقالا للسكرتير الأول لحركة صحراويون من أجل السلام السيد الحاج احمد باريكلى بعنوان “البوليساريو والرياح التي زرعتها”، تناول خلاله مسار الجبهة في قضية الصحراء الغربية، ووضعيتها التي صنعتها بيدها، وابرز التناقضات في سلوك القيادات التي تبسط سيطرتها على مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر.
نص المقال:
البوليساريو والرياح التي زرعتها
ينطبق المثل القديم “من يزرع الرياح يحصد العواصف”، بوضوح قاس على مسار جبهة البوليساريو، فكثير ممن شكّلوا نواتها الصلبة — رفاق نضال وشباب وأحلام — أصبحوا اليوم من أشد منتقديها، إنهم شهود عيان على كيف انتهى مشروع وُلد باسم التحرير، paradoxically، إلى تكريس المنفى الدائم والحرب، واضعًا الشعب الصحراوي في حالة تيه على حافة الهاوية.
بعد خمسين عامًا من حمل السلاح ضد إسبانيا بوعد الاستقلال والكرامة، تصل البوليساريو منهكة إلى مفترق طرق مصيري. فالاستنزاف التاريخي، والأخطاء الاستراتيجية، والانحراف السلطوي، والانقسام الداخلي، كلها عوامل قوّضت مصداقيتها وأضعفت قابلية مشروعها الانفصالي للحياة.
لقد جاءت المبادرة الأخيرة التي دفعتها الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن في أواخر أكتوبر — والداعية إلى حل سياسي قائم على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية — لتدفن عمليًا حلم “الجمهورية الأفلاطونية” في الصحراء الغربية.
والمفارقة المرّة أن هذه الصيغة تشبه إلى حد بعيد المقترح الذي كانت إسبانيا قد طرحته في الأيام الأخيرة من عهد فرانكو، والذي ازدرته البوليساريو ونسفته بعنجهية، في خطوة عجّلت بالانسحاب الإسباني وتوقيع اتفاقيات مدريد مع المغرب سنة 1975.
لقد كان رد فعل البوليساريو قَصر نظرٍ طفولي، ترتبت عنه عواقب كارثية، خلطت بين التعنت والشرف، وقررت تصعيد عمليات الاختطاف وحرب العصابات دون تقدير للسياق الدولي، وهكذا، وبأيديها، حفرت أسس واقع باتت الأسرة الدولية — وجزء كبير من الشعب الصحراوي — تنظر إليه اليوم بوصفه خطأً تاريخيًا فادحًا.
مفتونين بالخطاب الثوري للقذافي، وبالأخص بأموال نفطه، تخلّى أولئك المؤسسون الشباب — الفقراء والمأسورون برومانسية حركات الغوار في العالم الثالث — عن مشروع أولي اتسم بالغموض، إذ لم يكن واضحًا أبدًا هل كانوا يطمحون إلى استقلال المستعمرة الإسبانية السابقة أم إلى اندماجها في المغرب، كما كانت توحي به شعاراتهم الأولى سنة 1972، وبسبب قلة النضج وانعدام الخبرة، انساقوا وراء إغراء تحويل الصحراء الغربية إلى نسخة من “الجماهيرية” الليبية، دون إدراك أن تجربة كهذه كانت، في نظر الغرب، تعني إنشاء جيب موالٍ للاتحاد السوفياتي على ضفاف الأطلسي، وقد دفع الصحراويون ثمن تلك المجازفة دمًا ومنفى ونصف قرن من اللايقين.
من “التحرير” إلى التيه
نشأت النواة المؤسسة للبوليساريو في بلدة طانطان الفقيرة جنوب المغرب، مع ارتباطات قبلية محدودة بسكان الصحراء، وكان أغلب كوادرها الأوائل المتحدثون بالعربية فقط، وذوي التكوين المحدود، ينظرون منذ البداية بريبة إلى النخبة الصحراوية التقليدية وإلى الشباب الذين تكونوا في ظل الإدارة الإسبانية، والذين عرفوا مستوى معيشة وتطلعات أعلى نسبيًا.
وبدل دمج الرأسمال البشري الناطق بالإسبانية — الأكثر تكوينًا وتنظيمًا اجتماعيًا — اختارت البوليساريو تهميشه ضمن استراتيجية هندسة اجتماعية هدفت إلى تفكيك النسيج الداخلي. فمن خلال إحلال الولاء القبلي محل الهوية المشتركة، جرى إضعاف التماسك الاجتماعي عمدًا وتسهيل التحكم السياسي. وكانت الخطة بسيطة: إرسال الأكفأ إلى «منفى دبلوماسي»، بينما تركزت المناصب السياسية والعسكرية الحاسمة في دائرة طانطان، حيث صاغت القرابة الشخصية وحسابات السلطة قيادة منغلقة واحتكارية.
وهكذا تحوّل ما بدأ كحركة تحرير إلى بنية سلطة معتمة، أقرب إلى الطائفة منها إلى مشروع سياسي حديث، تاركة الشعب الصحراوي عالقًا في تيه بلا مخرج.
في مخيمات تندوف، حاولت القيادة فرض يوتوبيا ماوية غريبة عن الثقافة الصحراوية. ووصل الأمر حدّ التوصية بعدم صيام رمضان باسم «التقدم» المفهوم خطأ. وأُهين الأعيان التقليديون — بمن فيهم نواب سابقون في الكورتيس الإسبانية — وأُقصوا إلى مهام ثانوية. أما العائلات البدوية فحُشرت في مخيمات لاجئين، خاضعة لقواعد وممارسات دخيلة.
بلغ التدخل في الحياة اليومية مستويات عبثية: حتى ما يُطبخ داخل البيوت صار موضع قرار. وتم تفكيك الأسرة عبر فرض تصنيفات مثل «ثوريين» و«رجعيين»، «وطنيين» و«خونة». تلك بذرة كراهية ترسخت عميقًا وما زالت تسمّم علاقات القرابة حتى اليوم. ونُظمت النساء في لجان موحّدة الزي، بمهام محددة وجوقات تصفيق مُعدّة على الطريقة الكورية لقادة «الثورة». وكان هذا النظام الشكلي يخفي آلة قمع خانقة، ذات طابع أورويلي، نُصبت في قلب الهامادة الجزائرية.
وفي ظل هذا النظام، اختُطف مئات الصحراويين من خيامهم أو وحداتهم العسكرية بتهم واهية وسخيفة. وأصبح سجن الرشيد السري مركزًا للقمع، إعدامات خارج القانون، تعذيب بدائي، تجويع ممنهج، وإهانات متواصلة، خلّفت جرحًا لا يندمل في الذاكرة الجماعية.
وبلغ النفاق ذروته، ففي الوقت الذي اتُّهم فيه أبرياء بالتعاون مع (العدو)، كان كثير من القياديين يحتفظون بآبائهم في الجيش المغربي، وينقلون عائلاتهم إلى داخل التراب للاستفادة، دون خجل، من مساعدات ودعم (العدو) نفسه.
الانهيار الأخلاقي
منذ ذلك الحين، كان التدهور متواصلًا. فقد غادر آلاف الأشخاص — بينهم قادة تاريخيون وقادة ميدانيون أسطوريون — الحركة بحثًا عن ملاذ في المغرب. وبعد وقف إطلاق النار سنة 1991، شرعت عائلات كثيرة في هجرة صامتة نحو موريتانيا وأوروبا وإسبانيا. وهكذا أخذت البوليساريو تُفرغ تدريجيًا من أثمن رأسمالها البشري.
لقد أدى التعصب، وسوء استعمال السلطة، والجمود إلى تراجع الدعم الاجتماعي إلى أدنى مستوياته. وأضحى جزء متزايد من الصحراويين يشكك علنًا في قابلية مشروع الاستقلال، الذي اختطفته قيادة مسنّة وعاجزة. ففيما كانت الجماهير تعيش أوضاعًا قاسية في تندوف، كانت نخبة الحركة تُرسل أبناءها إلى أوروبا، بعيدًا عن المنفى والحرب. والمفارقة أن من استخدموا الخطاب المعادي لإسبانيا لتهميش السكان الأصليين، انتهوا إلى التنافس على الاستقرار في إسبانيا لتربية وتعليم ذريتهم في «الثقافة الاستعمارية» نفسها.
بالنسبة لكثير من الصحراويين، لم يعد المغرب هو العدو الأسطوري، بل صار شرًا أقل، أو فرصة، أو ببساطة ضمانة للاستقرار في مواجهة فوضى حركة ثورية فقدت منذ زمن ثورتها، وخارطة طريقها، ومستقبلها.
ويقع على عاتق صحراويي الداخل — وهم المتضرر الأكبر من هذه الرحلة الطويلة — استخلاص العبر واستعادة الدور الذي حُرموا منه لعقود. فبدل الاستمرار ككومبارس أو «أدوات طيّعة» لمصالح الآخرين، عليهم الإمساك بزمام مصيرهم والتوجه نحو مخرج مشرّف يضمن لهم الاستقرار والازدهار في أرضهم.
حفلة التيس الصحراوية
بسخرية مريرة، انتهت المنظمة التي وعدت بتحرير الشعب الصحراوي إلى أن تكون لعنته الكبرى، فبذبحها الأعراف الاجتماعية والحرية الفردية والعقل السليم باسم قضية مطلقة تُدار بولاءات قبلية وعصبوية، زرعت البوليساريو الرياح التي تحصدها اليوم: العزلة، وفقدان المصداقية، ومشروع سياسي يحتضر.
بعد نصف قرن، تبدو الحصيلة قاتمة. فجزء معتبر من الصحراويين يأسف لكونه انساق خلف «عصابة طانطان» في مغامرة طبعتها الطموحات الشخصية والارتجال. ولا يخفي قلة منهم شعورًا براحة مُرّة — لكنها راحة في نهاية المطاف — حين يتأكدون أن الجمهورية «الأفلاطونية» لم ترَ النور. فلو حدث ذلك، لربما انحدرت إلى نسخة إفريقية من «حفلة التيس»، تُنتج طغيانًا تغذّيه الصراعات القبلية والقمع، وربما حربًا أهلية.
سيضع الزمن والتاريخ كلَّ طرف في مكانه: أولئك الذين خرجوا من «النفق» بحثًا عن حلول واقعية، وقادة البوليساريو المتشبثين بمشروع مستحيل لم يُثمر سوى التضحيات والألم. وحتى يحين ذلك، تبقى حقيقة مُرّة: قضية وعدت بالكرامة انتهت مفترسة برياحها، تاركة شعبًا منهكًا وممزقًا، مضطرًا إلى إعادة اختراع مستقبله دون من أقسموا على بنائه فانتهوا إلى هدمه.
لجنة الإعلام والاتصال
مدريد، 18 ديسمبر 2025
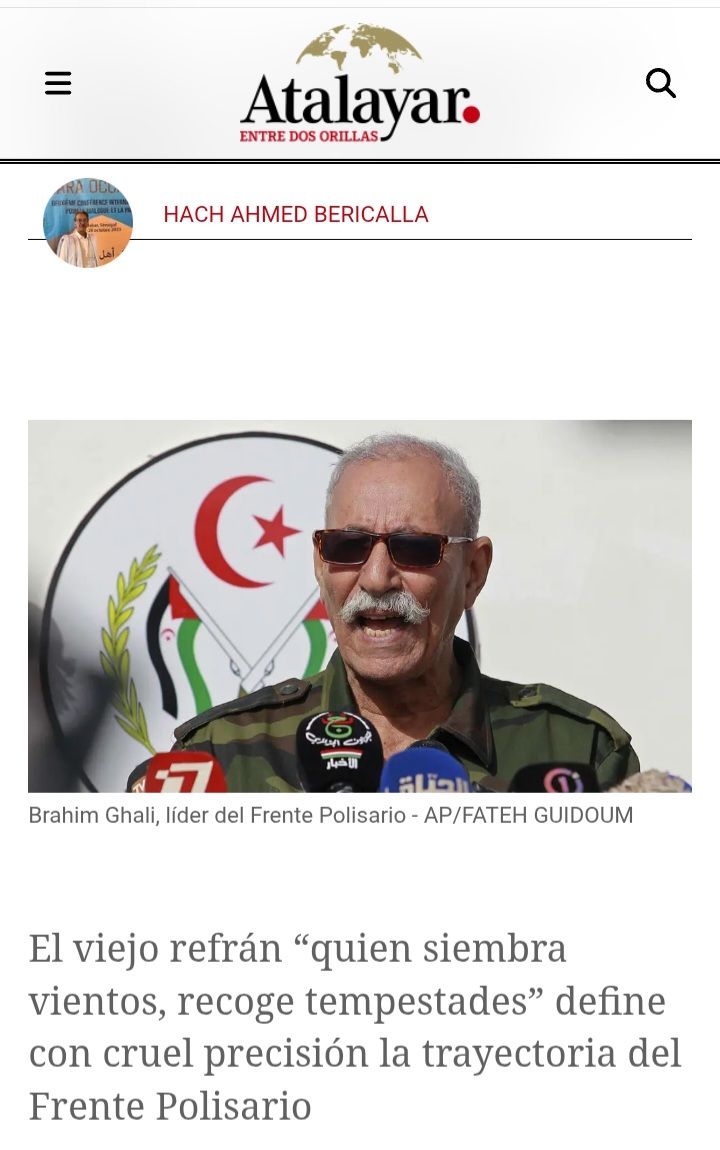













إرسال التعليق